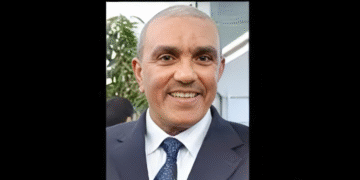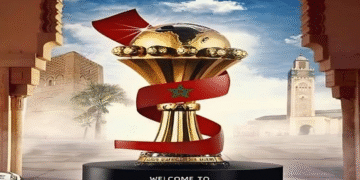من نحن
المساء 24 موقع إلكتروني إخباري مستقل بطاقم صحفي وإداري عالي التكوين يلتزم بالصحافة المجتمعية ويسعى إلى إحداث الفارق عما هو موجود .
خطه التحريري يتميز بالشفافية والدقة والموضوعية، ويؤمن بالرأي والرأي الآخر، يتلمس هموم المواطن ويعالج قضاياه من زوايامختصين وأخصائيين وخبراء .
المساء 24 يطرح الإشكالات ويبحث عن حلول لها، كما يحلل الواقع ويسعى للإجابة عنه .
يراقب الشأن العام المحلي والوطني ومسؤوليه، وهو بذلك صوت المجتمع، وفضاء إعلامي مفتوح للجميع، نحو الكلمة والرأي بكل مصداقية وبمحتوى جاد وراق .
المساء 24 النافذة الكبرى على أخبار مدن وجماعات هذا الوطن، ستبقى وفية لخطها التحريري المستقل والمحايد والمؤمن بالقيم العليا للوطن وشعبه، والمؤمن بالتغيير والعمل المسؤول في احترام تام لأخلاقيات المهنة والعمل الصحافي الحر .
طاقم الموقع الإلكتروني الإخباري المساء 24 سينقل لكم الحقائق والوقائع والمعلومات دون تحجيم أو تضخيم وبكل موضوعية ومهنية بعيدا عن الطعن في الأشخاص والمؤسسات والتشهير بها .
تفتح المساء 24 الإلكترونية صفحاتها لكل المواطنين ومن مختلف الاتجاهات والمناطق للتعبير عن آرائهم وانشغالاتهم، وستكون مستجيبة ومنصتة ومتفاعلة في الآن نفسه مع كل آهاته وانتظاراته أينما كان .