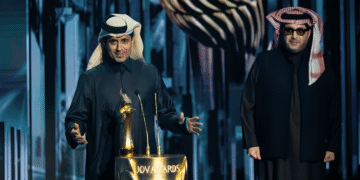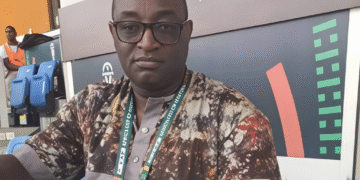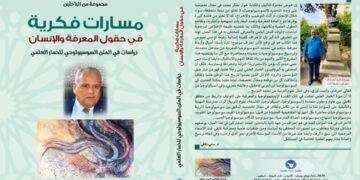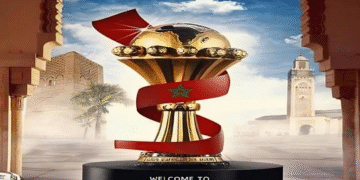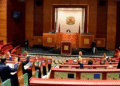بقلم: *ذ.عبدالإله فروات*
انطلاقا من وجهة نظرنا هذه حول المواطنة والدولة نستحضر بادئ ذي بدئ المألوف مما درجت عليه الفلسفة السياسية الحديثة من وصف المواطنين “كائنات سياسية” لا تولد من رحم الأمهات، ولا تجود بها السماء، وإنما تصنعها المؤسسات السياسية والقانونية بما تسنه من تشريعات تكفل الحقوق وتقويها بالضمانات الدستورية؛ وأيضا المؤسسات التربوية والتعليمية بما توفره من برامج لتكوين وتأهيل الأفراد بما فيها تلك ذات الصلة بالتربية على المواطنة، والتربية الأسرية على القيم التي تغرس حب المعرفة وتنميه في الناشئة، وقيم الحرية والاستقلال بالرأي وروح التضامن واحترام الآخرين وحب الوطن والاعتماد على الذات…؛ ناهيك عن المؤسسات الاجتماعية والمجتمعية من جمعيات وأحزاب ونقابات بما من المفروض أن ترسخه من قيم الدفاع عن القضايا العامة والمشتركة ومن قيم الحوار والتوافق والعمل المشترك ومن قيم الانضباط وربط المسؤولية بالمحاسبة.
عندما تنهض المؤسسات السالف بيانها بمسؤولياتها كحاضنة للمواطنة ، كل من موقعها وبما أتيح لها من ممكنات وإمكانيات، تتبدل حتما سلوكات الناس وتتغير طباعهم ويتحررون من قيودهم الكابحة لذاتيتهم والمكبلة لإرادتهم في إطلاق طاقاتهم الحرة منتقلين من حال الخوف والجهل والتواكل واليأس والسلبية إلى حال يدركون فيها حقوقهم المدنية والسياسية ويمارسونها ويدافعون عنها، حيث ينمو في ذهنهم الإحساس بالمشاركة الإيجابية في الشأن العام ويتشربون واجباتهم تجاه الوطن والدولة بتحررهم من ولاءاتهم الضيقة ومن مجرد احساسهم بالانتماء الى رقعة جغرافية الى إعلاء الولاء للوطن بما يفرضه من تضحية تمليها روح المواطنة.
ومن النافل القول إن المواطنة بهذا المعنى العميق صناعة كاملة يتأتى إنتاجها بمشاركة الجميع بتفاوت في الأنصبة والمستويات، وقطعا لا تنفرد بأمرها مؤسسة واحدة أو جهة بعينها، علما أن الخبرة التاريخية الحديثة تفيدنا أنه على الرغم من أن المشروع السياسي العام والشامل قمين بنقل فكرة المواطنة من حيزها النظري المجرد إلى حيز التحقيق المادي والمؤسسي، فإن التطور التاريخي، بشروطه الموضوعية والذاتية، يبقى عاملا مرجحا وحاسما في استنبات وتنضيج المواطنة وبنائها على أسس متينة وصلبة.
أما الدولة، وفي محاولة لتبديدنا بعض الالتباسات في علاقتها بالمواطنة والمجتمع، فهي مفهوم مجرد يستبطنه المجتمع كفكرة عليا كما يستبطن فكرة المواطنة أو القانون. يحترم الأفراد الدولة لأنه في احترامهم لها احتراما لأنفسهم كمجتمع وكمصالح مشتركة عليا وموحدة.
لكن الدولة لا تتبلور كفكرة في الوعي الجماعي المحسوس إلا حين تتجسد في هياكل ومؤسسات وأجهزة تنهض بوظائف إدارة المصالح تأطيرا وحماية؛ هذا الأمر ينتج عنه شعور مشترك وجماعي بالحاجة إليها والاحساس اليومي والمستمر بضرورتها واستشعار الفوائد والعوائد التي تجنى من قيامها بوظائفها والسهر على مزاولتها لمهامها.
إن الدولة كيان مجرد مجتمعي وسياسي يرمز إلى مجتمع بشري وقد تطور في هيأة نظام وشبكة من المصالح المشتركة وأجهزة ومؤسسات ترعى المصالح المتنوعة وتدير الشؤون العامة بوصفها تمثل المجموع الاجتماعي أو الأمة، هاجسها الرئيسي تجنب التدخل في الصراعات الاجتماعية الفئوية، فهي، أي الدولة، تبقى محايدة بتعاليها عن النزاعات الاجتماعية الجزئية لتتدخل فيما يعبر عن ماهيتها كدولة وهو حماية القانون الذي يمثل الإرادة العامة وفرض سيادته مع ردع المخالفات التي تهدد أمن المجتمع وتمس استقراره.
الحديث عن الدولة من هذا المنظور يقودنا حكما إلى التأكيد على أن التنافس على السلطة داخل الدولة لن يكون إلا محدود الحيز، وبيان ذلك أن المواطنين ينتخبون المؤسسات من برلمان وحكومة ومجالس ترابية وتقع المنافسة بين القوى على الأجهزة والهياكل في حيز ضيق صغير من أجل حيازة سلطة محدودة ضمن كيان الدولة؛ إلا أنه لا أحد يتصور انتخاب أفراد الجيش أو القضاة أو موظفي الدولة عموما، هؤلاء الذين يجسدون استمرارية وجود الدولة ويشكلون الجسم الأعظم في بنيتها، والذي يظل خارج المنافسة ويدير الشؤون العامة للبلاد حتى لو تعطل البرلمان أو توقفت المجالس المنتخبة أو تعذر تشكيل الحكومة، ومن هنا يظهر جوهر عمومية الدولة وحيادها وتعاليها عن النزاعات الفئوية والمنافسات المجتمعية.
وعلى ضوء ما سبق، نتأدى الى الخلاصة المركزية التي لا مناص منها وهي أن مفهومي المواطنة والدولة متلازمين مترابطين لا غنى لإحداهما عن الأخرى، كما أن الوعي المزدوج بهما والتشبع الجماعي بأهميتهما القصوى أمر لا محيد عنه في حياكة نسيج رصين من أواصر اللحمة وروابط الاندماج الاجتماعي.